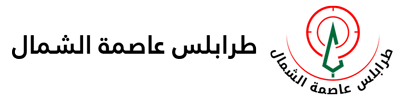ارتِفاع سِعر الحُرّية

تُرى ماذا يُريدُ الإنسان من هذه الحياة؟ سؤالٌ قد استَوطنَ ذِهني لسنوات كمُستأجِرٍ ثقيلِ الدم. هل يريدُ المال؟ البقاء؟ الخُلود؟ الشُهرة؟ السُلطة؟ الجاه؟ بصيغةٍ أخرى، ما هي الذُروةُ التي سنَصِلُ إليها في نهايةِ هذا المَطافِ الطويل المُسَمّى بالحياة؟ أو بالأحرى، ما هو الشيءُ الذي سنَذكرهُ و نَحمَدُ الله على حُصولِنا عليه و نحنُ على فراشِ الموت؟
أعلَمُ أن هذا سؤالٌ فلسَفيٌّ بَحت، فالفلسَفةُ امرأةٌ فُضوليةٌ تَدُسُّ أنفَها المَعقوفَ في كل التَخَصُّصاتِ و المَجالات الأخرى. في نظَري، إن كل عِلمٍ من العُلومِ البشَريةِ يَحمِلُ بُعدًا مُعيَّنًا من أبعادِ الفلسَفةِ الألف، و ربَّما يتَسَنّى لنا اكتِشافهُ في رحلَتنا الدِراسية أو لا، ذلك يعتَمِدُ اعتمادًا كُلّيًا على حجمِ المَساحةِ الفِكرية التي يَهَبُها المَرءُ لعَقله كي يُبحِرَ إلى ما وراءِ بِحارِ الحَقائِق،
و هذا الإبحارُ هو بعَينه تلك العمَليةُ المُسمّاةُ بالتفَكُّرِ و التَدَبُّر، و التي ذُكِرَت مرّاتٍ كثيرةً في القرآن الكريم. ففي عِلمِ الفلسَفة، يبحَثُ الإنسانُ عن الحَقيقةِ أو عن أقرَبِ صورةٍ لها.
و كذلكَ في التَفَكُّرِ و التدَبُّر، فما التدَبُّرُ سوى البحثِ عن لمسةِ الله تعالى في كل شيءٍ حولَنا، أو نستطيعُ القَولَ أنه عمليةُ تَقَصّي الإعجازِ في هذا الكون، و المَعنَيانِ مُتَشابِهانِ جدًا.
دائمًا ما أكتبُ عن الفلسَفةِ في نُصوصي و مَقالاتي، و على الأرجَحِ أنّي أجهَلُ السببَ الواضِحَ وراءَ حُبّي للفلسَفة. كما نعلَم، لكل شيءٍ جانبٌ مُظلِمٌ أو سَلبي، مهما كان ذلك الشيءُ جميلاً، و أظُنُّ أن القمرَ خيرُ مثالٍ على هذه القاعِدة.
إنَّ لصَديقَتي الفلسَفة جانبٌ مُظلمٌ أيضًا، و هو الاستِفزاز. غالبًا ما تَستَفِزُّ الفلسَفةُ العُقولَ المُستَنيرة، إنها تستَثيرُنا لنَعصِرَ ألبابَنا حتي تنتَفِضَ في أعماقِنا صَرخة، حتى تُطالِبَنا عُقولُنا المسكينةُ بالرَحمة، دائمًا أقولُ أن الفلسَفةُ هي جَلادُ العُقول،
و تَحديدًا عُقول المُفَكِّرين، ذلك أنها تستَمِرُّ بتَعذيبِ العَقلِ و جَلدهِ بسوطِ المَنطِق حتى يَعتَرِفَ ذلك المُفَكِّرُ المسكينُ بسَطحيةِ أفكاره، فدائمًا هناكَ قاعٌ أعمَقُ للفلسَفة.
أذكرُ أن أحدَ أساتِذَتي في الجامعة، و الذي كان يُدَرِّسُني مادّة الفلسَفة آنذاك في جامعة ويسترن الكنَدية، قالَ لي ذات مَرّةٍ أن الفلسَفةَ ما هي إلا زِلزالٌ يَهُزُّ أيديولوجياتِنا الثابِتة و يُزَلزِلُ قَناعاتنا الراسِخة.
و لا شكَّ أن هذا الوصفَ بالغُ الدِقّة، فالفلسفةُ لم تَكُن يومًا خَطًا مُستَقيمًا مُكوَّنًا من سببٍ و نَتيجة، بل هي تفتحُ لك بابًا فِكريًا آخرَ في اللحظةِ التي تَظنُّ فيها أنك قد وصَلتَ إلى آخرِ جِدار.
إن الفلسَفةَ من مَنظوري الضَيق هي جَريمةٌ كُبرى، و كلما تعتَقِدُ أنك قد حَلَلتَ اللُغزَ أو وصَلتَ إلى طرَفِ الخَيط، تَجِدُ أمامكَ دَليلاً آخرَ و أطرافًا كثيرةً لخيوطٍ مُتَشابِكة. و قد قادَتني عَصا الفلسَفة إلى إجابةِ ذلك السؤالِ المَطروح في بدايةِ المَقال، و تتكَوَّنُ تلك الإجابةُ من كلمةٍ واحدة: الحُرّية.
يبحَثُ الإنسانُ دومًا عن الحُرّية، في مُختلَفِ العُصورِ و الأزمِنة، ذلك أن الفِطرةَ هي بذرةُ الإنسان، و الحُرّيةُ هي قِمّةُ الفِطرة. عندما يولَدُ طفلٌ إلى هذا العالَم، يُقطَعُ ذلك الحَبلُ السُرّيُّ الذي يَربطهُ بأمّه، فيصبِحُ حُرًّا طَليقًا بعد أن كان حَبيسَ رَحمٍ ضَيق، يَغدو حُرًّا مُنفَصِلاً بعد أن كان مُرتَبِطًا بكَيانٍ آخر.
تلك هي أولُ رَشفةٍ من كأسِ الحُرّية. ثم تسيرُ بنا قافِلةُ الحياة، و نستَمِرُّ بالبحثِ عن أنماطٍ أخرى للحُرّية، في مُحاوَلاتٍ مُستَميبتةٍ للعودةِ إلى الفِطرة، إلى تلك الصفحةِ البيضاءِ التي لم تُلَوَّث، لكن الفِطرةَ تبدأُ بالتَلاشي شيئًا فشيئًا.
إن حقيقةَ هذه الحياة هي أنها رحلةُ بحثٍ مُستَمِرّةٍ عن الحُرّية، و بالأخَص حُرّية الاعتِقادِ و التَصديقٍ و التفكير. لكنَّنا نَجِدُ بعد أن يلتَهِمُ النُضجُ أرواحَنا، و بعد أن نَمُرَّ بمَراحلِ الحياة و نُصبِحَ أعضاءَ فَعّالينَ في العالمِ الخارجي، نَجِدُ أن هذه الحُرّيةَ تَنقَشِعُ تَدريجيًا من سَماواتِنا اللامُتَناهية،
ذلك أن أولئكَ “الآخَرينَ” سيبدأونَ باقتِحامِ مَساحةِ حُريَّتنا كجُزءٍ من طُقوسِ البُلوغِ أو نوعٍ من إثباتِ الوَعي و الرَشادِ لديهم. يبدأُ أولئكَ “الآخرون” بتَصميمِ القَوالبِ الضَيقةِ ليَضَعونا داخلَها كالكَعكِ الجاهزِ للتَقديم، ثم نُقَدَّمُ على أطباقٍ من ذهبٍ أو فِضّة – ذلك يعتَمِدُ اعتِمادًا كُلّيًا على الحَظ – على مائدةٍ مليئةٍ بالأصنافِ المُنافِسة، لا نفعلُ شيئًا سوى أننا ننتَظِرُ بعضَ الأيادي التي قَد تمتَدُّ نحوَنا، مُتَعَلِّقينَ بالقَد كالغَرقى. و كلما ازدادَت الأيادي التي تَنتَقينا كلما ازدادَ شعورُنا بقيمَتنا الذاتية.
في الواقع، نحنُ لا نريدُ شيئًا سوى الحُرّية، و أستطيعُ اختِصارَ هرمِ ماسلو للاحتياجات في كلمةٍ واحدة: حُرّية. فنحن مجرَّدُ كائناتٍ بسيطةٍ باحثةٍ عن مساحةٍ لمُمارسةِ الفِطرة، نبحثُ عن مكانٍ هادئٍ ليتَسَنّى لنا الإنصاتُ إلى ذلك الصوتِ الطُفولي الخافتِ في أعماقِنا، ألا و هو صوتُ الشغفِ الحَقيقي، الصوتُ العفَويُّ الذي اعتَدنا على تَجاهُلهِ للأسف.
طوالَ سنواتِ حياتي القصيرة، لم أرِد شيئًا سوى أن أكونَ حُرّة، حُرّةً في مساحَتي و تَفكيري، دون أن أضعَ رقَبَتي تحت مِقصَلةِ الاحتِمال، حيث سأغدو فَريسةً مُقتَسَمةً بالعَدلِ بين القُبولِ و الرَفض.
لا شكَّ أن الحُرّيةَ هي أثمَنُ عُملةٍ في هذا العالم، و من هذا المُنطلَق يجبُ إعادةُ تشكيلِ الاقتصادِ العالَمي. و بالنسبةِ لي،
أن يكونَ المَرءُ حُرًّا يعني أن يَمتَلِكَ القدرةَ على أن يكونَ نفسهُ و يُمارسَ حَقيقتهُ دون أدنى شعورٍ بالذنبِ أو العار، لأن هاذانِ الشُعورانِ هما ما يَدفَعانِنا إلى ارتِداءِ وجوهٍ غير وجوهِنا، وجوهٍ لم نَعرِفها. لابُدَّ أن يمتَلِكَ الإنسانُ حُرّيةَ الاختيار، و كما يقولُ الأستاذ نعوم تشومسكي:
“يجبُ أن نتَذكَّرَ أن الحُرّيةَ وهمٌ و خداعٌ عندما تغيبُ القُدرةُ على مُمارسة الاختيار الحُر.” و الخَياراتُ قد تتغَيَّرُ عبرَ الزمن، و هذا أمرٌ طبيعيٌّ جدًا لأن أفكارَنا في تغَيُّرٍ و تبَدُّلٍ مُستَمر.
أحيانًا تتمَلَّكُ الإنسانَ رغبةٌ عارِمةٌ في إحراقِ مَساراته القَديمة و اختيارِ طريقٍ مُختلفٍ تمامًا، إنها رغبةٌ في الحيادِ عن كل تلك الطُرُقِ المُستَقيمةِ و المِثالية، إذ يُدرِكُ فجأةً أنه لا بأسَ بقَليلٍ من الاعوِجاج، فالقَصيدةُ المَنظومةُ لا تَغارُ من الارتِجال، كما أن اللَوحةَ لم تَقُل يومًا أنها ضَدَّ سياسةِ الخَربَشة.
في رأيي، لقد آنَ الأوانُ لأن نُعطي كامِلَ الثقةِ إلى عَفَويَتنا، أن نُسَيِّجَ أنفُسَنا بالحُرّيةِ العازِلةِ للحَتمياتِ و الضَمانات، أن نَرقُصَ على حافّاتِ المَخاطِر حتى نَسقُط، نحنُ جيلٌ نحتاجُ إلى المُرونةِ و التَحَرُّرِ أكثرَ من حاجَتنا إلى الخُبز، فقَرقَرةُ البطنِ المؤقَّتةِ خيرٌ من قَرقرةِ النفسِ الأبَدية.
بعد كِتابَتي لهذا المَقال، قَرَّرتُ أن أخلَعَ حِذائيَ الضَيّق و أرقُصَ الباليه في شارعِ أحلامي، هناك تحتَ أمطارِ النَقدِ الغَزيرة، و وسطَ ذُهولِ شَخصياتي الألف.
بقلَم الكاتِبة مينا بشير